بقلم أنور السمراني
الذكاء الاصطناعي يجمع الكمّ الهائل من المعلومات التي يُدخلها البشر إلى شبكة الإنترنت، ويستعمل أنظمة على مستوى بالغ من الدقة ليربط في ما بينها، مستخلصًا الاستنتاجات والإجابات والاقتراحات، وحتى الحلول التي تناسب موضوع البحث.
إلّا أنّ الأساس يبقى ”الإنسان أوّلًا وآخرًا“. وكأنّ كلّ انطلاقة تبدأ بما كُتب على الصفحات الأولى لمنشورات علم الإيزوتيريك بقلم د. جوزيف ب مجدلاني (ج ب م): ”الهدف هو الإنسان دائمًا وأبدًا“. حتى القاعدتين الأولى والثانية لبرامج عمل الروبوتات هي: ١- يجب ألّا يتسبب الروبوت في حدوث أذى للبشر، و٢- يجب على الروبوت أن يطيع الأوامر التي يصدرها له الإنسان، إلّا إذا تعارضت مع القاعدة الأولى.
ما هو الأهم في الحياة؟
 يذكر الإيزوتيريك أنّ كلّ ما في الوجود هو لمساعدة الإنسان على درب الوعي، إلّا أنّ الإنسان نفسه لا يعي أهمية هذا الأمر… فتراه تائهًا عن حقيقة نفسه، وبالتالي عن المحور الأهم… والنتيجة، أقلّه، مضيعة للوقت الذي يبقى أثمن ما نملك.
يذكر الإيزوتيريك أنّ كلّ ما في الوجود هو لمساعدة الإنسان على درب الوعي، إلّا أنّ الإنسان نفسه لا يعي أهمية هذا الأمر… فتراه تائهًا عن حقيقة نفسه، وبالتالي عن المحور الأهم… والنتيجة، أقلّه، مضيعة للوقت الذي يبقى أثمن ما نملك.
لنسأل أنفسنا إذًا: ما هو الأهم في الحياة؟ وإذا كان التطور العلمي يقدّم لنا التكنولوجيا لتسهيل أمورنا، فما بالنا نسهو عن الهدف الأساس؟
أوضحت مؤلفات علم الإيزوتيريك، لا سيما سلسلة ”تعرّف إلى…“ بقلم الدكتور مجدلاني (ج ب م)، ماهية الفكر والذكاء، وقدّمت طرق عملية وتمارين حياتية لتفتيحهما رويدًا رويدًا، وصولًا إلى الإبداع الحقّ، الذي يرنو إلى تفتيح المعرفة في النفس بهدف توسيع الوعي الفردي فالعام، كما يستفيض في الشرح أيضًا كتاب ”عالم الفنون“ بقلم (ج ب م). من هنا ينبغي التوضيح أنّ تطوير الوعي عبر تفتيح الباطن، لا يمكن أن يتحقق دونما الغوص في معرفة علم الإيزوتيريك وتطبيقها حياتيًّا بغية تحقيق التطور على الصعيدين المادي والباطني في آن معًا… هذا مبدأ عام ينطبق على كلّ ما نواجهه في حياتنا.
والجدير بالذكر أنّ التطور التكنولوجي هو الجانب المادي من التطور الإنساني.
في هذا السياق، نلاحظ أنّنا نندمج في التكنولوجيا في معظم الأحيان تاركين الفكر جانبًا، فيبدأ الفكر بالخمول، ونصبح مسمّرين قبالة الهواتف الجوالة أو الحواسيب إلى حد الإدمان…
الذكاء الاصطناعي – أداة مساعدة
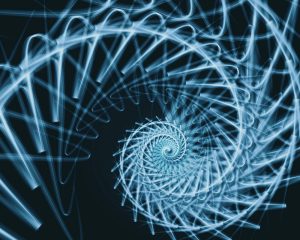 في ما يلي بعض الطرق العملية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة مساعدة لاختصار الوقت، بدل أن يكون مدعاة للإدمان والكسل الفكري:
في ما يلي بعض الطرق العملية لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة مساعدة لاختصار الوقت، بدل أن يكون مدعاة للإدمان والكسل الفكري:
* التركيز على هدف البحث وتحديد النواقص التي علينا تعلّمها بغية استكماله.
* الانتباه إلى أن يكون العمل متكاملًا بدلًا من أن يكون ميكانيكيًّا جافًا.
* عدم استعمال الإجابات التي تأتي من الذكاء الاصطناعي من دون تمريرها على شاشة وعي الباحث وتجربته الفردية…
* حصر استعمال الذكاء الاصطناعي في الأعمال الروتينية التي تختصر الوقت والطاقة، وذلك بغية استعمال طاقتنا وتشغيلها في الأمور التي تتطلب إعمال الفكر وتوسيع المدارك.
* عدم الاسترسال في مشاركة الذكاء الاصطناعي بمعلومات خاصة لا يريد الباحث مشاركتها علنًا. (مع الإشارة إلى أنّ استعمال الذكاء الاصطناعي في الشركات التجارية على سبيل المثال يخضع لقوانين صارمة هدفها المحافظة على أسرار الشركة والموظفين، إلخ…).
يذكر كتاب ”تعرّف إلى ذكائك“ بقلم (ج ب م) ص. 13-14: ”الذكاء يمثّل المقدرة على الاكتشاف والتجدد والخلق… فيما الحاجة إلى التعلّم والارتقاء هي التي تحثّ الفكر على التفاعل والابتكار“. لكن يبدو أنّ ذكاءً من نوع آخر بات الشغل الشاغل للأكثرية في هذه المرحلة… فرفيقنا الدائم بات الهاتف ”الذكي“ الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان. كما أصبح الذكاء الاصطناعي موضة الحاضر وقاعدة المستقبل. ولا ننسى الذكاء المشاعري (Emotional intelligence) الذي أخذ رواجًا كبيرًا في العقود الماضية ولا يزال.
لكن، متى يا ترى سيعي الإنسان أنّ الانطلاقة الصحيحة نحو الإبداع تبدأ من الداخل، من التعرف إلى نفسه أوّلًا عبر اعتماد مؤلفات ”تعرّف إلى فكرك“ و”تعرّف إلى ذكائك“، على سبيل المثال لا الحصر؟ متى يا ترى سيعي الإنسان أنّ التعرف إلى نفسه يبدأ بالتعرف إلى محوره الإنساني عبر معرفة علم الإيزوتيريك؟!






very interesting article